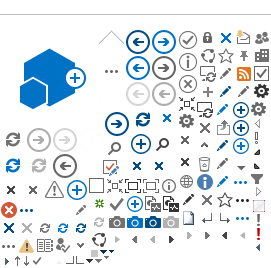بقلم بدر الحاج
ترجمة سلام شغري
أفضل تقييم لأعمال صليبا الدويهي (١٩١٣- ١٩٩٣) التشكيلية هو ما يعرضه الدويهي شخصيا من آراء في تجربته الفنية. هنا ملخص سريع لأحاديث مطولة مسجلة أجريتها معه في الفترة ما بين ١٩٨٢ و ١٩٨٦ عندما ترك الولايات المتحدة الأمريكية في لندن. في تلك الأحاديث يسرد الدويهي سيرته الذاتية، ويقدم تصوراته وقناعاته في كيفية تطور الفن التشكيلي الذي أنتجه ما بين أواسط الثلاثينيات من القرن الماضي وحتى أواسط الثمانينيات.
التقيت للمرة الأولى بالدويهي في بروكلن في شتاء ١٩٨١. كان يقيم في غرفة كبيرة تقع على سطح الكنيسة المارونية، ويعيش كالنساك في غرفة متواضعة تمتلئ بالمئات من اللوحات والرسوم التي أنتجها في مراحل مختلفة. كنا في لبنان نعرف الدويهي بلوحاته التي تبرز الطبيعة الريفية، وكان من الفنانين اللبنانيين البارزين الأربعة الذين أطلق عليهم اسم "الأربعة الكبار" وهم: عمر فروخ وقيصر الجميل وعمر الأنسي والدويهي. لكن ما شاهدته في محترفه اختلف اختلافاً جذريا عن إنتاج زملائه، إذ شق الدويهي لنفسه طريقًا فنيا متميزاً وفريداً في مسيرة الفن التشكيلي في لبنان والعالم العربي.
في أحاديثه المسجلة والطويلة عاد الدويهي إلى أيام الطفولة في زغرتا واهدن، ثم انتقاله إلى بيروت سنة ١٩٢٨ لدراسة الرسم في محترف الفنان حبيب سرور (١٩٣٨- ١٩٦٠)٬ وسفره سنة ١٩٣٢ إلى باريس لمواصلة دروسه في فن الرسم والتصوير، ثم عودته إلى لبنان سنة ١٩٣٦ وانهماكه في إنجاز رسوم كنيسة الديمان ورسم المناظر الطبيعية في وادي قاديشا.
في آذار (مارس) عام ١٩٥٠ هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وعاد إلى لبنان سنة ١٩٥٥ وانكب على إنجاز رسوم ولوحات كنيسة مار يوحنا المعمدان في مسقط رأسه زغرتا، ثم عاد ثانية إلى الولايات المتحدة وزار لبنان سنة ١٩٧٢ حيث أنجز الرسوم الزجاجية الملونة لكنيسة مار شربل في عنايا، وفي سنة ١٩٧٨ أنجز ٦٥ عملاً زجاجيا مصوراً لكنيسة سيدة لبنان في جامايكا بلاين بالقرب من بوسطن.
أمضى الدويهي بضعة سنوات (١٩٨٢- ١٩٨٦) في لندن ثم انتقل إلى باريس وتوفي سنة ١٩٩٣.
اعتبر الدويهي أن مسيرته الفنية تنقسم إلى أربع مراحل هي التالية:
المرحلة الأولى: البدايات والدروس الأكاديمية.
المرحلة الثانية: رسم الطبيعة اللبنانية وإنجاز رسوم كنيسة الديمان.
المرحلة الثالثة: وهي التي أسماها الدويهي المرحلة المخضرمة، وفيها أنتج لوحاته التي تتأرجح بين التجريدي والطبيعة.
المرحلة الرابعة: هي المرحلة التجريدية التي تلخص تجربته الفنية.
هنا ملخص مكثف لما قاله الدويهي وهو خليط من السيرة الذاتية والآراء في مسيرته الفنية وتقييمه لمعاصريه من الفنانين.
البدايات
أنا من مواليد زغرتا سنة ١٩١٣ ، أتذكر جيداً أنني كنت أتعلم القراءة والكتابة في مدرسة تحت أشجار الجوز في مار بطرس- إهدن. كان المعلم بطرس الدويهي قاسياً جداً على التلاميذ. درسني قواعد الخط العربي سليمان عيرون، وكنا نطالع في كتاب بعنوان "معرض الخطوط العربية".
انتقلت للدراسة في مدرسة الفرير في زغرتا وكنت أقوم بنسخ صور عن كتب "لافونتين" وغيره. كان والدي يصنع أخشاب البنادق ويحفرها بطريقة فنية، كما كان يرسم الزخارف والنقوش على الحديد، وكنت أساعد الوالد في عمله بحفر الخشب ونقش الحديد.
بعد أن أنهيت دروسي في مدرسة الفرير في زغرتا اقترح البعض إرسالي إلى روما أو الفاتيكان لدراسة فن الرسم. في تلك الأيام كان المرجع الأول لمثل تلك القرارات البطريركية المارونية. هناك اقترح أحد الرهبان أن أبدأ أولاً بالدراسة على يد الفنان سرور، على أن يعود لسرور بعد ذلك القرار فيما إذا كان من المستحسن إرسالي إلى الخارج لمتابعة دروسي أم لا. أعجب سرور برسومي وقال لي إنك بحاجة إلى مزيد من التدريب والدرس واقترح عليَّ أن ألتحق به في محترفه في منطقة الجميزة في بيروت.
لازمت حبيب سرور عدة سنوات، وقد تبناني كابن له وعلمني أصول الرسم، لكن لا بد من القول إن سروراً لم يفتح أمامي دروب الفن الحديثة، كان يريد أن تكون الصورة مدروسة حسب الأصول، ودائماً كان يركز في أحاديثه معي على معارضته الاتجاهات الجديدة في الفن.
أما من ناحية الألوان، لم يكن عندي في تلك الفترة أية براعة فيها، لم يسمح لي سرور بالتلوين. تقييمي لتصاوير سرور أنها كلاسيكية وجميلة جدا، تضاهي أعمال أهم المصورين الإيطاليين، لكنها في نهاية الأمر محلية وأفقها محدود جدا. وأكثريتها تشبه تصاوير زملائه أمثال داود القرم، فيليب موراني وخليل الصليبي، وتنحصر في صور الكنائس وكبار الشخصيات ورجال الدين.
كنت أنا وقيصر الجميل والعمرين فروخ والأنسي من الجيل الثاني من الفنانين بعد جيل الرواد (سرور وموراني والصليبي وداود القرم) وعلى الرغم من النجاح الذي حصدناه والمعارض التي أقمناها، إلا أنني كنت أشعر أن هناك نقصاً كبيراً في أعمالي. لذلك هاجرت إلى الولايات المتحدة سنة ١٩٥٠ للتعمق في مدارس الفن الحديثة، ونجحت، أما زملائي فاستمروا في العمل ضمن نفس الدوامة. لا أريد أن يفهم من كلامي هذا أنني أظلم الجميع، ربما لأن الجو الثقافي المحلي السائد في لبنان لم يكن يتيح لهم المجال لفتح الآفاق والتفتيش عن أساليب فنية جديدة. كانت الموضة أن ينتظر الفنان وصول الزبون ليلبي رغبته وفي أكثر الأحيان إذا انعدم وجود الزبون ينعدم الرسم.
كنت أقرأ كتابات جبران والمنفلوطي، وكانت كتبهما رائجة. وأذكر أنني سمعت بوفاة جبران عندما كنت أعمل في محترف حبيب سرور. أما عن رأيي في أعمال جبران خليل جبران الفنية فإنني أعتبر جبران نسيج وحده وأجدها شاعرية وتعبر عن تمرده، والبيئة التي ترعرع فيها جبران هي نفسها البيئة التي ترعرعت فيها.
أعود إلى مرحلة الدراسة مع حبيب سرور فأقول إن السنوات الأربع التي قضيتها في محترفه استفدت منها في دراسة وتفهم كيفية الرسم وتجويد مهارتي، وقد ساعدت معلمي في تصاويره.
إلى باريس
سنة ١٩٣٢ أوفدتني الحكومة اللبنانية على نفقتها للدراسة في باريس. قدمت امتحاًنا في أكاديمية الفنون الجميلة العليا، ونجحت وكنت الطالب الثاني من حيث العلامات بين مئات الطلاب، وكانت علاماتي ممتازة وخاصة في علم الهيئة إذ نلت ١٩ درجة على ٢٠ في مادة الرسم بفضل ما تعلمته على يد حبيب. أجازت لي تلك العلامات أن أكون طالباً في مدرسة الفنون الجميلة العليا ودخلت الأكاديمية وبدأت العمل في وهو من الفنانين الأكاديميين "بول ألبير لورانس" محترف البارزين، وبدأت بتصوير النساء والرجال العراة. وأمضيت في باريس ما يقارب أربع سنوات وأجدت خلال الدراسة الرسم، لكن لم يكن لديَّ أي إلمام أو اهتمام فيما يدور حولي من الاتجاهات والتيارات الفنية الحديثة. كنت أذهب مع بعض زملائي الفنانين إلى المعارض الفنية، لكن ولعي وشغفي كان كلاسيكيًّا محضاً، وكل شيء خارج الكلاسيكية كان في نظرنا مضيعة للوقت.
أنجزت في السنوات التي أمضيتها في باريس لوحات عديدة واشتركت في معارض من بينها معرض الفنانين الفرنسيين "Salon des artistes français" وعرضت لوحة بعنوان"La Vénus de Milo" وهي تمثل تمثال فينوس الموجود في متحف اللوفر.
بقيت متمسكاً بالأصول الكلاسيكية البصرية التشكيلية إلى أن انتهت دراستي في باريس وعدت إلى لبنان سنة 1936. من ذكريات المرحلة الباريسية أنني التقيت في أكاديمية الفنون بالفنان العراقي فائق حسن. كانت رسوم فائق مدار إعجاب أستاذه.
في لبنان
بعد عودتي إلى لبنان تركز نشاطي على استلهام الطبيعة اللبنانية. قمت بتصوير القرى والمنازل والأودية والأديرة والفلاحين. كنت أرسم الطبيعة كما هي بدون تشويه. التصاوير الريفية التي أنجزتها حملت بصمات تلك المرحلة التي فيها الصدق أكثر من غيرها. أمضيت ما يقارب الشهر بين معلولا، مكسه ودمشق، ورسمت عشرات اللوحات. بعد ذلك ذهبت إلى بيروت وافتتحت محترففاً في شارع محمد الحوت.
بدأت العمل بتصوير سقف كنيسة الديمان في أواخر "مايكل أنجلو" الثلاثينيات، وكنت مسروراً كوني أرسم بطريقة فالمشاهد الكلاسيكية كانت تبرز العضلات وحركات "رفائيل والجسد والمناظر الطبيعية.
في تلك الفترة بدأت المطالعة عن الفن الحديث وكنت أطلع على رسوم حديثة كانت في عيون معظم الناس مشوهة، لكنها كانت بالنسبة إليَّ جميلة، وشيئًا فشيئًا أصبحت أكثر ميلاً إلى تلك الرسوم، وأصبحت على يقين بأن الفن هو الخلق وليس تقليداً للطبيعة. الطبيعة شيء والفن شيء آخر.
وازدادت معرفتي في هذه الناحية لدرجة مثلً عندما كنت أرسم صورة فيها بحر، والبحر عادة أزرق اللون، كنت أضع اللون الأحمر بدل الأزرق، باعتبار أن ما يهمني ليس المنظر بقدر ما يهمني تناسق الألوان بعضها مع بعض.
في تلك المرحلة بدأ عندي شغف بالسفر إلى الخارج، ففي لبنان كنت معروفًا بما فيه الكفاية، وكانت الصحف تتحدث عن أعمالي سواء بعد إنجاز رسوم كنيسة الديمان أو في المعرض في بيروت " سان جورج" الفني الذي أقيم سنة 1945 في فندق للأسف انعدم النقد الفني في بلادنا في تلك المرحلة، النقد عادة يعلم الفنان ويصوب اتجاهه، ويشجعه على التقدم، لكن ما اصطلح على تسميته النقد في لبنان كان عبارة عن إطراء ومدح أو ذم. لذلك رأيت أنه إذا بقيت في لبنان وواصلت العمل بنفس الأسلوب، فإن شهرتي ستكون محصورة في محيط ضيق، وبأنني سوف أكرر نفسي من دون إبداع وخلق، لكل ذلك قررت الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
إلى أمريكا
زودتني الحكومة اللبنانية بجواز سفر شبه رسمي، وغادرت لبنان في آذار (مارس) ١٩٥٠ ووصلت إلى نيويورك مروراً بباريس. عندما وصلت إلى نيويورك بدأت العمل في محترفي وانهمكت بالدراسة، عالم فني جديد وواسع تفتح أمام عيني. كنت أقوم بالرسم ليلاً ونهاراً إلى أن بدأت طلائع الفن الحديث تتبلور أمامي وذلك في مطلع الخمسينيات. كنت أستمع إلى المحاضرات، وأدرس الفنون العالمية القديمة والحديثة وأستعير الكتب الفنية من المكتبات العامة، تعرفت إلى التكعيبية، والسوريالية، والانطباعية... إلخ. هكذا وعبر تلك الدراسات تفهمت الحركة الفنية العالمية وبدأت بالعمل الجاد لإيجاد موقع لي على الخريطة الفنية.
كنت أصور من دون أن أنتمي إلى أية مدرسة فنية محددة، أو أنسخ فناًنا وأنسج على منواله. أحببت أن أكون نسيج وحدي. قمت بإنتاج أعمال حديثة مستمدة من الاختبارات الفنية التي أنجزتها في لبنان. بمعنى آخر أن الدويهي الذي رسم في لبنان الطبيعة اللبنانية، عاد وصور تلك الطبيعة في أمريكا بطريقة تجريدية لكن أساسها متوسطي شرقي. لذلك فإن كل من شاهد أعمالي التجريدية قال إنها نسخة طبق الأصل عن رسومي القديمة، لكن بطريقة تجريدية.
كنت أصور كما كنت أحس وأشعر وأريد. لم أكن راضيًا في أول الأمر عن أعمالي الكلاسيكية، باعتبار أنها في مذهبي الخاص قديمة الأسلوب، وهناك عديد من الذين يستطيعون التصوير مثلها أو أفضل، وهي في نهاية الأمر تدور حول موضوع محدود جدًّا هو الطبيعة اللبنانية.
الآن تبدلت نظرتي إلى تلك الأعمال وأصبحت أميل إليها باعتبار أنها كانت أساس انطلاقتي في رحاب الفن التجريدي الحديث. إذا أردت يمكنني أن أبرهن لك على سبيل المثال كيف أن لوحة تمثل دير مار قزحيا في وادي قاديشا، بعد رسم ثلاث أو أربع صور عن تلك اللوحة يمكن أن تصبح اللوحة الرابعة والأخيرة مجردة بالنسبة إلى اللوحة الأصلية الأولى. يكون ذلك باختصار الخطوط، وانعدام الانحناءات الكلاسيكية واختفاء الجزئيات وأصبح الخط الكبير يدل على فسحة متكاملة واحدة من دون أجزاء أو تقاطيع. وأكثر لوحاتي التجريدية اليوم تمثل خطوطًا تنم عن البحر المتوسط، إنني في الواقع فنان متوسطي، والأمر الجميل بالنسبة إلى تصاويري التجريدية الجديدة أنني انتهيت من الاستدارة الكلاسيكية، والتبسيط في الفسحة عندي هو تبسيط عربي كالخط العربي. أصبحت هناك في أعمالي فسحة واحدة بدون أبعاد ثلاثية.
كما ذكرت سابقًا نظراً لانعدام النقد الفني طغت على بلادنا موجات أوروبية قوية سواء سياسية، أو حربية أو فنية، وبهرتنا تصاوير الغرب لأنها تمثل الطبيعة، كالقول الشائع "تصاويرهم ما بدها غير تحكي." باعتقادي هذه الأمور البصرية لا معنى لها في مفهوم الفن الحديث.
أعود إلى موضوع أعمالي التجريدية، وأقول شخصيا لديَّ ناحيتان في التجريد، الناحية الأولى مستندة إلى الخط العربي، والناحية الثانية لا علاقة لها بالخط العربي ويطلق عليها البعض الناحية الأمريكية.
عندما أقمت معرضا فرديا في نيويورك عام ١٩٦٦، معظم النقاد أكدوا أن صاحب اللوحات ليس أمريكيا، إنه متوسطي من حوض المتوسط. بالطبع هذا الموقف مبني على إدراكهم لألواني ونوعية الشكل، فالأمريكي يصور بأشكال وألوان أخرى. ليس لي علاقة باللون الأمريكي أو الفن الأمريكي البتة.
أما أعمالي المستندة إلى الخط، فأذكر جيداً أنه منذ ما يقارب ال ٣٥ سنة باشرت في تلك الأعمال. بالنسبة إليَّ لم أر أجمل من الخط الكوفي الذي يستمد روحه من الخط السرياني. كتبت لأول مرة عن أهمية الخط مقالاً طويلاً في مجلة "الشعلة" في بيروت دعوت فيه الفنان العربي أن يتخذ الخط شعاراً لفنه وأسلوبه وعمله الدائم. يقول ابن عربي: "إن الحرف سر من أسرار الله والعلم به من أشرف العلوم المخزونة عند الله". إن حرفاً واحاً من الحروف العربية يمكن أن يصبح لوحة عظيمة
في عالم الفن، اللهم شرط أن يدرك الفنان كيفية الدخول إلى لب الموضوع وإخراجه إخراجاً فنياً دقيقاً.
نقطة أخيرة أود الإشارة إليها حول أعمالي التجريدية. لقد سبق لي أن شرحت تلك الأعمال في رسالة إلى ناقد فني حين قلت: "في الآونة الأخيرة عرضت أمامي بعض أعمالي الحديثة لوحة فرأيت أن الحجم قد تهذب وأثبت وجوده أكثر من ذي قبل".
رأيت الألوان زاخرة بالحياة النضرة وبالحرارة فهي لا تقترب من الطبيعة بشيء بل في صورة خيالية رمزية إيجازية. الألوان أصبحت ذات معنى. بحد ذاتها، الخطوط اختصرت واستقامت في صعود. رأيت مشكلة البعيد المنظور وقد تطورت حجماً ولوناً واقتربت من المسافات الأولية، وكذلك المسافات المتوسطة زحفت إلى الخط الأمامي فجاء التركيب لحمة أو بنياًنا مرصوصاً، فالزيادات والحشو والنقرات الانطباعية البصمات التي تنم عن إحساس عابر بين لون ولون، كل هذه الصفات تلاشت واضمحلت وحل مكانها البناء المحكم والمختصر جدًّا. ويصح لي القول بهذا الصدد ما قاله ابن الأثير إزاء البلاغة في اللغة العربية: "الإيجاز أولى بالاستعمال من الحقيقة في باب الفصاحة والبلاغة".
لقد توصلت إلى الحد الأقصى من الاختصار والإيجاز. ألم يقل ابن يحيىى: "وإذا قدرتم أن تجعلوا من كتبكم توقيعات فافعلوا". إن عملاً فنيا كعملي يتطلب من دون أدنى شك هدوءًا وسلاماً متكاملاً عميقاً، وما ذلك إلا نوع من الورع والعبادة.
كنيسة مار يوحنا زغرتا
عام ١٩٥٥ عدت إلى لبنان بعد أن كلفني قبلان المكاري إنجاز رسوم كنيسة مار يوحنا المعمدان في زغرتا. قبل البدء بالعمل قمت بعدة أبحاث حول الفنون الشرقية، واطلعت على نماذج من الفن البيزنطي، والمخطوطات السريانية المزينة بالرسوم والتي تعود إلى الجيل السادس، وعلى الأناجيل المحفوظة في مكتبات باريس، وفلورنسا، واطلعت على الفن الآشوري والفارسي والخط السرياني السترلنكي استناداً على تلك الخلفية، وبصورة خاصة الفن البيزنطي المشبع بالروح السريانية التي أعطته طابعاً خاصًّا أنجزت رسوم كنيسة زغرتا. إن رسوم الإنجيليين الأربعة في كنيسة زغرتا مستوحاة من الفن الآشوري. فالمبدعون الآشوريون كانوا خلاقين حيث جمعوا في جسم واحد أربع مدهشات الخلق، الإنسان والنسر كملك الطيور والأسد كسيد للغابة، والثور الذي مثَّل الخصب. ومنذ الألف الثالث وحتى اليوم لا تزال الحضارات الإنسانية تتناقل هذه الرموز التي هي تعبير عن لغة الخلق التي لا تتغير.
الرسم على الزجاج
هذا الموضوع عزيزعليَّ وأعلق عليه أهمية كبرى. عندما بدأت الرسم على الزجاج رأيت أن الزجاج بحد ذاته أقوى من اللون الذي أضعه على القماش. في أعمالي على الزجاج رأيت أن اللون بحد ذاته يشع منه النور درجات مختلفة حسب الضوء الخارجي المسلط عليه. كان أهل بلادي في الزمان القديم يستعملون الزجاج في الغرف المظلمة كي تخف حدة العتمة! لقد انطلقت من هذه الفكرة وبدأت بتقطيع وتكسير الألواح الزجاجية بحيث تعكس ضوءًا ساطعاً يصعب أن ينبثق من لوحة على القماش.
لاحظت أن الفنانين الذين صنعوا الزجاجيات التقليدية القديمة في بيوت العبادة أو القصور الفخمة كانوا يستعينون بالقضبان الحديدية والرصاص الذي له لون أسود بهدف إلصاق القطع الزجاجية بعضها ببعض.
شاهدت مثلاً صورة شخص يمشحها لون الرصاص الأسود الأمر الذي شوه كما أعتقد الصورة، وفي نفس الوقت اضطر فنان العصور السابقة إلى اللجوء لاستعمال الرصاص كمادة لاصقة للقطع الزجاجية. من هنا لجأت إلى أسلوب جديد مختلف تمامًا عن الأسلوب التقليدي. قمت بإلغاء مادة الرصاص واستعملت مادة لاصقة أخرى لزجة وغير مرئية تسمى إيبكوس، والتي لم تكن معروفة في السابق فهي من الاختراعات الحديثة، فأصبح بإمكاني إلصاق قطع الزجاج بعضها فوق بعض، وبذلك تلاشت عتمة الرصاص وتحولت زجاجياتي إلى وهج من النور القوي المضيء.
مسألة تقنية أخرى أود الإشارة إليها في هذا القبيل، وهي أنه إذا ما سطعت الشمس على قطعة زجاجية خضراء وبقربها قطعة صفراء وبينهما خط أبيض، فإن الألوان تعكس وهجاً خاصاً، وهذا الوهج يتلألأ عندما تنظر إليه العين كأنه في حركة دائمة. لقد قررت أن أتابع في هذا الاتجاه، وقمت باختبارات دامت ما يقارب ال ١٢ عاماً، وأنجزت بذلك الأسلوب ابتداءً من العام ١٩٧٢ نوافذ كنيسة مار شربل في عنايا والتي للأسف دُمِّر قسم منها من قبل القوى المتصارعة خلال الحرب الأهلية.
فمن شاهد نوافذ كنيسة مار شربل بأحجامها المختلفة يدرك كم أن نور لبنان الطبيعي قد ساعدني على إنتاج تلك الأعمال التي تفوق جمالاً الأعمال التي أنجزتها في كنيسة سيدة لبنان بالقرب من بوسطن. هكذا أصبحت الكنيستان مكاناً للصلاة ومتحفاً وانعكاساً لحضارة وثقافة عمرها آلاف السنين.
إن الرسم على الزجاج عمل شاق، ويجب على الفنان اتخاذ احتياطات كثيرة. لكن على الرغم من صعوبة العمل في هذا الحقل فإنني أجد عزاء كبيراً عندما أنظر إلى أعمالي التي تطلق نوراً وهاجاً لا تراه في رسومي الزيتية. إن ما يهمني في هذه الأعمال هو وهج النور المنبثق منها وبهجة الألوان الصارخة الجميلة.